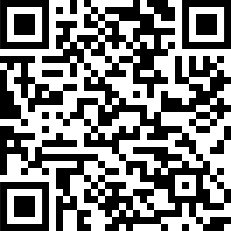النقاط الرئيسية
1. قادة أوروبا يشرفون على انتحار حضاري.
عندما أقول إن أوروبا في طريقها لقتل نفسها، لا أعني أن عبء تنظيمات المفوضية الأوروبية أصبح ثقيلاً أو أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تفعل ما يكفي لتلبية مطالب مجتمع معين.
قرارات القادة. المسار الحالي لأوروبا ليس عرضياً، بل هو نتيجة لقرارات اتخذها قادتها. يبدو أن هؤلاء القادة فقدوا الثقة في الحضارة الأوروبية، حيث يظهرون قلة الرغبة في الدفاع عن تقاليدها أو قيمها. وقد أدى ذلك إلى سياسات تقوض الهوية الفريدة والتراث الثقافي للقارة.
الانحدار الحضاري. يجادل المؤلف بأن أوروبا لا تواجه تحديات سياسية أو اقتصادية فحسب، بل أزمة وجودية. القارة تفقد إرادتها في البقاء، وإحساسها بالهدف، وقدرتها على الدفاع عن مصالحها. هذا الانحدار يتجلى في التحولات الديموغرافية، والتفكك الثقافي، وتآكل القيم التقليدية.
اللامبالاة والشعور بالذنب. أحد العوامل الرئيسية في انحدار أوروبا هو الشعور الواسع بالذنب وعدم الثقة بالنفس الذي يعاني منه قادتها ومفكروها. ينبع هذا الشعور من الماضي الاستعماري للقارة ودورها في الصراعات التاريخية. ونتيجة لذلك، أصبحت أوروبا مترددة في تأكيد مصالحها أو الدفاع عن ثقافتها، مما أدى إلى قبول سلبي لانحدارها.
2. نقص العمالة بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى هجرة جماعية، مما غير هوية أوروبا.
في جميع دول أوروبا الغربية، بدأت هذه العملية بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نقص العمالة.
عواقب غير مقصودة. بدأت الهجرة الجماعية إلى أوروبا استجابةً لنقص العمالة بعد الحرب العالمية الثانية. كانت برامج العمال الضيوف تهدف في البداية إلى أن تكون مؤقتة، لكنها أدت إلى استقرار دائم ولم شمل الأسر، مما غير التركيبة العرقية والثقافية للدول الأوروبية بشكل جذري.
التحولات الديموغرافية. أدى تدفق المهاجرين، وخاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة. في العديد من المدن الأوروبية، أصبح "البريطانيون البيض" ومجموعات أوروبية أصلية أخرى أقلية في عواصمهم. وقد أدى ذلك إلى توترات ثقافية وقلق بشأن مستقبل الهوية الأوروبية.
فقدان التماسك الثقافي. يجادل المؤلف بأن الهجرة الجماعية قد أضعفت التماسك الثقافي للمجتمعات الأوروبية. مع نمو المجتمعات المهاجرة، غالباً ما تحافظ على لغاتها وعاداتها وأديانها، مما يؤدي إلى مجتمعات موازية وضعف القيم المشتركة. هذا التفكك يجعل من الصعب الحفاظ على إحساس بالهوية الوطنية والتضامن الاجتماعي.
3. المبررات الاقتصادية للهجرة في أوروبا غالباً ما تكون مضللة.
طوال الوقت، وجد الأوروبيون طرقاً للتظاهر بأن هذا يمكن أن يعمل. من خلال الإصرار، على سبيل المثال، على أن مثل هذه الهجرة كانت طبيعية. أو أنه إذا لم يحدث الاندماج مع الجيل الأول، فقد يحدث مع أطفالهم أو أحفادهم أو جيل آخر قادم.
أساطير اقتصادية. يدعي مؤيدو الهجرة الجماعية غالباً أنها ضرورية للنمو الاقتصادي ولمواجهة شيخوخة السكان. ومع ذلك، يجادل المؤلف بأن هذه الادعاءات غالباً ما تكون مضللة. بينما يساهم بعض المهاجرين في الاقتصاد، يعتمد العديد منهم على برامج الرعاية الاجتماعية، مما يضع ضغطاً على الموارد العامة.
الإسكان والخدمات. أدت الهجرة الجماعية أيضاً إلى زيادة الطلب على الإسكان والمدارس والرعاية الصحية، مما زاد من الضغط على الخدمات العامة. يشير المؤلف إلى أن المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تحتاج إلى بناء مدينة بحجم ليفربول كل عام لاستيعاب سكانها المتزايدين، والذي يقوده بشكل كبير الهجرة.
ضغط الأجور. يمكن أن يؤدي تدفق العمالة الرخيصة إلى خفض الأجور للعمال ذوي المهارات المنخفضة، مما يزيد من عدم المساواة الاقتصادية. يستشهد المؤلف بدراسات تظهر أن المهاجرين غير المنتمين للمنطقة الاقتصادية الأوروبية قد استهلكوا في الواقع خدمات أكثر مما دفعوه من ضرائب، مما كلف المملكة المتحدة مليارات الجنيهات.
4. حجة "التنوع" تخفي تآكل الثقافة والمشاكل الاجتماعية المستوردة.
من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الناس، من الضروري وضع تعريف شامل وشامل للإدماج.
تعريفات ذات عمق سطحي. ينتقد المؤلف التركيز على "التنوع" كقيمة أوروبية أساسية، arguing that it has led to a shallow self-definition that lacks the depth and historical roots necessary to sustain a culture. القيم مثل "الاحترام" و"التسامح" ليست كافية لربط المجتمع معاً، خاصة عند مواجهة تحديات ثقافية كبيرة.
المشاكل الاجتماعية المستوردة. أدت الهجرة الجماعية أيضاً إلى استيراد مشاكل اجتماعية، مثل الاغتصاب الجماعي، وجرائم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يجادل المؤلف بأن هذه الممارسات غالباً ما تكون متجذرة في مواقف ثقافية تتعارض مع القيم الأوروبية، وأن الصواب السياسي قد منع السلطات من معالجة هذه القضايا بشكل فعال.
قمع المعارضة. لقد خنق الخوف من أن يتم تصنيفهم على أنهم "عنصريون" أو "إسلاموفوبيون" النقاش المفتوح حول التحديات التي تطرحها الهجرة الجماعية. وقد خلق ذلك مناخاً من الرقابة الذاتية، حيث لا يمكن حتى الحقائق الواضحة حول هذه الأمور أن تُقال دون المخاطرة بالتهميش الاجتماعي أو المهني.
5. العولمة ليست عذراً للهجرة غير المنضبطة.
العالم يدخل إلى أوروبا في اللحظة التي فقدت فيها أوروبا رؤية ما هي عليه.
أسطورة الحتمية. يتحدى المؤلف فكرة أن الهجرة الجماعية هي نتيجة حتمية للعولمة. يشير إلى أن دولاً مثل اليابان والصين تمكنت من تجنب الهجرة الجماعية على الرغم من كونها لاعبين رئيسيين في الاقتصاد العالمي.
خيارات السياسة. يجادل المؤلف بأن الهجرة الجماعية ليست قوة لا يمكن إيقافها، بل هي نتيجة لخيارات سياسية اتخذتها الحكومات الأوروبية. تشمل هذه الخيارات مزايا الرعاية الاجتماعية السخية، ورفع القيود على الحدود، وموقف مرحب تجاه طالبي اللجوء.
استعادة السيطرة. يقترح المؤلف أن أوروبا يمكن أن تستعيد السيطرة على حدودها من خلال اعتماد سياسات هجرة أكثر صرامة، وتقليل مزايا الرعاية الاجتماعية للوافدين الجدد، وتعزيز إحساس أقوى بالهوية الوطنية. هذه التدابير، رغم أنها مثيرة للجدل، ستكون ضرورية للحفاظ على الثقافة والقيم الأوروبية.
6. لامبيدوزا والجزر اليونانية هي الخطوط الأمامية المأساوية لأزمة الهجرة في أوروبا.
أولئك الذين كانوا مستعدين للتحدث ومشاركة قصصهم كانوا بالضرورة مجموعة مختارة ذاتياً. كانت هناك أوقات، أثناء الانتظار خارج مخيم في المساء، عندما ظهر أشخاص أو عادوا بدوا – على أقل تقدير – غير مقبلين على قارتنا بروح من الكرم أو الامتنان.
الضعف الجغرافي. أصبحت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية والجزر اليونانية في بحر إيجه نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون لدخول أوروبا. قربها من شمال إفريقيا وتركيا يجعلها وجهات جذابة لمهربي البشر.
التكلفة البشرية. الرحلة عبر البحر الأبيض المتوسط محفوفة بالمخاطر، ويموت العديد من المهاجرين في البحر. يصف المؤلف مراكز المهاجرين المكتظة في لامبيدوزا والمقابر المؤقتة حيث تُدفن جثث المهاجرين الغارقين.
استياء محلي. أدى تدفق المهاجرين إلى الضغط على موارد المجتمعات المحلية في هذه الجزر، مما أدى إلى الاستياء والتوترات الاجتماعية. يشير المؤلف إلى أن السلطات المحلية غالباً ما تُترك للتعامل مع الأزمة بمفردها، مع القليل من الدعم من بقية أوروبا.
7. سياسة الباب المفتوح لميركل في 2015 سرعت تحول أوروبا.
في ذروة الأزمة في سبتمبر 2015، سألت المستشارة ميركل من ألمانيا الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عما يمكن فعله لوقف المواطنين الأوروبيين عن كتابة انتقادات لسياسة الهجرة الخاصة بها على فيسبوك.
لحظة حاسمة. كانت قرار المستشارة أنجيلا ميركل في سبتمبر 2015 بفتح حدود ألمانيا للاجئين السوريين نقطة تحول في أزمة الهجرة الأوروبية. كان هذا القرار، رغم أنه مدفوع بمخاوف إنسانية، له عواقب بعيدة المدى على القارة.
عامل الجذب. خلقت سياسة الباب المفتوح لميركل "عامل جذب"، مما شجع الملايين من المهاجرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا على طلب اللجوء في أوروبا. أدى هذا التدفق إلى إرباك أنظمة اللجوء في القارة وزيادة الضغط على نسيجها الاجتماعي.
تآكل الثقة. يجادل المؤلف بأن قرار ميركل اتخذ دون استشارة الشعب الأوروبي وضد رغبات العديد من الدول الأعضاء. وقد أدى ذلك إلى انهيار الثقة بين الناخبين وممثليهم السياسيين، مما غذى صعود الأحزاب الشعبوية والمعادية للهجرة.
8. فشل التعددية الثقافية في خلق مجتمعات متماسكة.
كما هو الحال مع العديد من الأوهام الشعبية، هناك شيء في هذا. لقد كانت طبيعة أوروبا دائماً متغيرة – كما تظهر المدن التجارية مثل البندقية – وقد شملت انفتاحاً كبيراً وغير عادي على الأفكار والتأثيرات الأجنبية.
مجتمعات موازية. يؤكد المؤلف أن التعددية الثقافية، كما تم تنفيذها في أوروبا، فشلت في خلق مجتمعات متماسكة. بدلاً من ذلك، أدت إلى نمو مجتمعات موازية، حيث تعيش المجتمعات المهاجرة حياة منفصلة عن السكان الرئيسيين.
تآكل القيم المشتركة. كما أضعفت التعددية الثقافية القيم والتقاليد المشتركة التي كانت تربط المجتمعات الأوروبية معاً. يجادل المؤلف بأن التركيز على التنوع جاء على حساب الوحدة، مما جعل من الصعب الحفاظ على إحساس بالهوية الوطنية والتضامن الاجتماعي.
الحاجة إلى الاندماج. يدعو المؤلف إلى التحول بعيداً عن التعددية الثقافية نحو سياسة الاندماج، حيث يُتوقع من المهاجرين تبني اللغة والقوانين والعادات في بلدهم المضيف. سيساعد ذلك في خلق مجتمع أكثر تماسكاً وتوحيداً، مع احترام حقوق وتقاليد المجموعات الأقلية.
9. الشعور الفريد بالذنب في أوروبا يشل قدرتها على الدفاع عن ثقافتها.
أكثر من أي قارة أو ثقافة أخرى في العالم اليوم، تعاني أوروبا الآن من عبء ثقيل من الذنب بسبب ماضيها.
عبء تاريخي. تتحمل أوروبا عبءاً فريداً من الذنب بسبب ماضيها الاستعماري، ودورها في الصراعات التاريخية، ومعاملتها للمجموعات الأقلية. وقد أدى هذا الذنب إلى تردد في تأكيد مصالحها أو الدفاع عن ثقافتها.
عدم الثقة والنقد الذاتي. يجادل المؤلف بأن هوس أوروبا بماضيها قد خلق ثقافة من عدم الثقة والنقد الذاتي. وقد جعل ذلك من الصعب على الأوروبيين أن يفتخروا بإنجازاتهم أو يدافعوا عن قيمهم.
الحاجة إلى التوازن. يدعو المؤلف إلى نهج أكثر توازناً تجاه التاريخ، يعترف بأخطاء القارة الماضية بينما يحتفل أيضاً بإنجازاتها. سيساعد ذلك في استعادة إحساس بالفخر الوطني والثقة الثقافية، مما يمكّن أوروبا من مواجهة تحديات المستقبل بعزيمة أكبر.
10. جهود الإعادة إلى الوطن هي في الغالب مجرد تظاهر.
هذه الجهود أيضاً ستفشل. من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الناس، من الضروري وضع تعريف شامل وشامل للإدماج.
نقص الإرادة السياسية. على الرغم من القلق العام المتزايد بشأن الهجرة الجماعية، كانت الحكومات الأوروبية مترددة في تنفيذ سياسات فعالة للإعادة إلى الوطن. ويرجع ذلك إلى مجموعة من الاعتبارات السياسية، والعقبات القانونية، ونقص الموارد.
التحديات العملية. حتى عندما تصدر أوامر الترحيل، غالباً ما يكون من الصعب تنفيذها. ترفض العديد من الدول استعادة مواطنيها، وعملية تحديد وتتبع المهاجرين غير الشرعيين يمكن أن تكون مستهلكة للوقت ومكلفة.
الحاجة إلى نهج واقعي. يجادل المؤلف بأن أوروبا بحاجة إلى اعتماد نهج أكثر واقعية تجاه الإعادة إلى الوطن، يعترف بحدود النظام الحالي ويركز على إزالة أولئك الذين يشكلون تهديداً للسلامة العامة أو ليس لديهم حق في البقاء. سيساعد ذلك في استعادة ثقة الجمهور في نظام الهجرة وردع الهجرة غير الشرعية في المستقبل.
11. التعب الوجودي وفقدان المعنى يزيدان من انحدار أوروبا.
الهجرة الجماعية – استبدال أجزاء كبيرة من السكان الأوروبيين بأشخاص آخرين – هي إحدى الطرق التي تم تصور هذه القصة الجديدة: تغيير، كما بدا لنا، كان جيداً مثل الراحة.
فراغ روحي. يجادل المؤلف بأن أوروبا تعاني من تعب وجودي، وإحساس بأن قصتها قد نفدت وأنه ليس لديها ما تقدمه للعالم. هذا الفراغ الروحي جعل من الصعب على الأوروبيين مقاومة قوى التآكل الثقافي والتغيير الديموغرافي.
فقدان الإيمان. أدى تراجع المسيحية وأنظمة الاعتقاد التقليدية الأخرى إلى ترك فراغ في قلوب وعقول العديد من الأوروبيين. وقد أدى ذلك إلى شعور بعدم الانتماء ونقص في الهدف، مما يجعل من الصعب العثور على معنى وإشباع في الحياة.
الحاجة إلى التجديد. يدعو المؤلف إلى نهضة ثقافية وروحية في أوروبا، تعيد اكتشاف التراث الفريد للقارة وتوفر إحساساً جديداً بالهدف والاتجاه. سيساعد ذلك في استعادة إحساس بالأمل والتفاؤل، مما يمكّن أوروبا من مواجهة تحديات المستقبل بثقة أكبر.
12. هناك حاجة إلى نهضة ثقافية وروحية لإنقاذ أوروبا.
كان ستيفان زفايغ محقاً في التعرف على الاضطراب، ومحقاً في التعرف على حكم الإعدام الذي أصدرته مهد وحضارة الغرب على نفسها.
استعادة الهوية الأوروبية. يؤكد المؤلف على ضرورة أن تعيد أوروبا اكتشاف تراثها الثقافي والروحي الفريد. يتضمن ذلك الاحتفاء بإنجازات القارة في الفن والموسيقى والأدب والفلسفة والعلوم.
الدفاع عن القيم الأوروبية. يدعو المؤلف إلى التزام متجدد بالدفاع عن القيم الأوروبية، مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. يتطلب ذلك استعداداً للوقوف في وجه أولئك الذين يسعون لتقويض هذه القيم، سواء من الداخل أو الخارج.
دعوة للعمل. يختتم المؤلف بدعوة للعمل، urging Europeans to resist the forces of decline and to work towards a brighter future for their continent. يتطلب ذلك استعداداً لمواجهة الحقائق الصعبة، وتحدي الحكمة التقليدية، واحتضان إحساس جديد بالهدف والعزيمة.
آخر تحديث::
مراجعات
تتلقى موت أوروبا الغريب آراء متباينة، حيث يثني الكثيرون على تحليله المدروس لقضايا الهجرة في أوروبا. يقدّر المؤيدون شجاعة موري في تناول المواضيع المثيرة للجدل ونقده للنخب السياسية الأوروبية. بينما يجادل النقاد بأن الكتاب يحمل طابعًا كارهًا للأجانب، ومبالغًا فيه، ومناورًا. يجد بعض القراء أن الكتاب يفتح آفاقًا جديدة ويدعو للتفكير، بينما يرفضه آخرون باعتباره دعاية عنصرية. تثير مناقشة الكتاب حول الهوية الأوروبية، والتغيرات الثقافية، وتحديات الاندماج نقاشات حادة بين المراجعين.
Similar Books